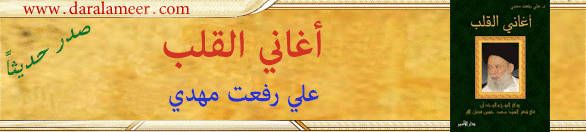علم الكلام ومنهج المناظرة **
بقلم: د. طه عبد الرحمن .
1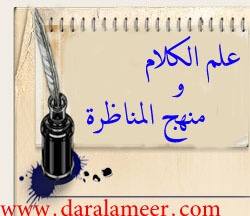 - تجديد الاعتبار لعلم الكلام
- تجديد الاعتبار لعلم الكلام
1. 1- مكانة المناظرة في الإنتاج الإسلامي:
إذا صح أن ما يميز الفلسفة عن غيرها من أصناف المعرفة الإنسانية ويمنحها منهجية مخصوصة هو أسلوب "المناظرة"، صح معه بالضرورة أن كل قطاع معرفي يكون حظه من العمل الفلسفي على قدر انتهاجه لهذا الأسلوب "المناظري".
وما صدقت هاتان الحقيقتان المتلازمتان: إمكان قيام الفكر الفلسفي في كل قطاع معرِفي أياً كان من جهة، وانتهاج الفلسفة لأسلوب المناظرة من جهة أخرى، مثل صدقهما على الإنتاج الفكري الإسلامي، إذ لم يطبَّق ولم يعمَّم منهج على جميع مجالات المعرفة مثلما طُبِّق وعُمِّم منهج المناظرة في هذا التراث، فأكسبه خصباً فلسفياً متميزاً.
فقد أقيمت مجالس للمُحاورة عُرفت ب"المناظرات" كما وضعت تآليف على طريقة المناظرة في مختلف الميادين، وظهرت صنوف من الخطابات تقر بالمناظرة منهجاً فكرياً مثل "خطاب التهافت" و"خطاب التعارض" و"خطاب الرد" و"خطاب النقض" وما إليها؛ بل حيثما وُجِدت مذاهب ومدارس واتجاهات في مجال من مجالات المعرفة الإسلامية، كانت المناظرة طريقة التعامل بينها، وهذا شأن الفقه (باب الخلاف) والنحو (باب القياس) والأدب (النقائض)، ولم تكن المناظرة وجه تفاعل التيارات التي تنتسب إلى قطاع علمي واحد فحسب، بل طبعت أيضاً التعامل بين أهل العلم من قطاعات مختلفة (المناظرة بين أبي سعيد السيرافي النحوي ومتَّى بن يونس الفيلسوف).
وإذا أدخلنا في الاعتبار أمراً آخر وهو الدعوى التي تقول بأن اللغة تحمل سمات فكر من يتكلمونها، فإن غنى معجم المناظرة في اللغة العربية ليدل بحق على تداول المسلمين الأغلب لهذا المنهج الجدلي والتزامهم به أكثر من غيره في تحصيل المعرفة وتبليغها، ونذكر من هذا المعجم، لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال، مجموعةَ المفردات التالية، وهي، بالإضافة إلى لفظي "المناظرة" و"المحاورة" و"المخاطبة" و"المجادلة" و"المحاججة" و"المناقشة" و"المنازعة" و"المذاكرة" و"المباحثة" و"المجالسة" و"المفاوضة" (في معناها القديم) و"المراجعة" و"المطارحة" و"المساجلة" و"المعارضة" و"المناقضة" و"المداولة" و"المداخلة" وأخرى غيرها كثير.
2.1- إفادة المناظرة اليقين:
وإذا اتضح لنا أن طريقة المناظرة الجدلية تشمل كل مناحي الفكر الإسلامي، وكنا نعلم، من جهة أخرى، أنها في عُرف من تأثر بأرسطو تفيد الظن وحسب في مقابل منهج المنطق الذي يقيد اليقين، أيعني هذا أن الجزء الأكبر من المعرفة الإسلامية لا يرقى إلى مستوى اليقين ويكون طلبه غير نافع ولا واجباً؟
نرد على هذا السؤال من الوجوه الثلاثة الآتية:
1.2.1- إن النظار المسلمين وضعوا لمنهج المناظرة شروطاً وقوانين تنافس في استيفائها وضبطها وصرامتها وترتيبها ضوابط المنطق وأحكامه، باعتباره علماً لقوانين العقل؛ ولا أدلّ على ذلك من أنهم استخدموا طرق الجدل في الاستدلال على قضايا من صميم المنطق نفسه، وبهذا فتحوا الطريق أمام مشروع رد المنطق إلى الجدل: هذا المشروع الذي يترتب عنه أن النظر العقلي هو في أصله مناظرة، وأن ما يدعى "بالعقلانية" إن هو إلاّ "مُعَاقَلَة".
2.2.1- إن الأساليب الرياضية الحديثة التي صيغ فيها المنطق انتهت إلى ترجيح أسلوب جدلي في هذه الصياغة؛ فبعد أن كان المناطقة، في مرحلة أولى، يكتفون بتقنين صور الألفاظ وتراكيب العبارات دون النظر إلى معانيها من صدق أو كذب (المرحلة التركيبية)، أخذوا في مرحلة تالية يجعلون لمدلولات الألفاظ ومضامين العبارات دوراً حاسماً في هذا التقنين (المرحلة الدلالية)؛ ومنها إلى مرحلة ثالثة جددوا فيها الاعتبار للمتكلم والمخاطب بوصفهما متناظرين يطلبان تمييز الصواب من الخطأ، وفي هذا ما يزكي كامل التزكية المنْحى الذي جنح إليه المسلمون في جعل علم المنطق جزءاً من علم المناظرة وإلباسه لباس الجدل.
3.2.1- إن اليقين الذي ينبني عليه الجدل هو يقين عملي، بينما اليقين المنطقي هو يقين نظري، صناعي، صوري، واليقين العملي أقوى على التوجيه وأقدر على التغيير من اليقين النظري، وهذا اليقين الذي لا يُنتفع به ويظل حبيس القول والقرطاس.
3.1- "علم المناظرة العقدي" أو علم الكلام:
وإذا كانت أغلب المعارف الإسلامية آخذة بمسلك المناظرة الجدلي، فإنها تفاوتت في درجة التقيد به على قدر الافتقار إليه بمُقْتَضى نوعية شروطها المعرفية، ولم يأخذ أيُّ مجال علمي إسلامي بهذا المنهج مثلما أخذ به "علم الكلام" ـ هذا العلم الذي قام على تواجه العقائد سواء بين أصحاب الملة الواحدة أو بين أصحاب الملل المختلفة ـ حتى إننا نرى أحق أن يدعى "علم المناظرة العقدي" من أن يدعى باسم آخر، فيكون "رجل الكلام" أو "المتكلم" هو من قام بالشروط الآتية: بأن كان:
1.3.1- معتقداً: يقوم اعتقاده في التسليم بما ورد في كتاب الله والسنة المحمدية تسليم المكلف من لدن الشرع؛ واعتباراً لهذا الجانب سُمِّيَ علم الكلام ب"علم التوحيد" وعلم "الموجود بما هو موجود" على قواعد الإسلام.
2.3.1- ناظراً: لما كان النظر هو طلب الفكر لشيء مخصوص سالكاً إليه طرقاً مخصوصة يعتقد أنها قادرة على الظفر به، فإن المتكلم يطلب تعقل أصول العقيدة وتعقيلها، وذلك بأن يسلك فيها سبل الاستدلال والإقناع، مما أدى إلى تسمية "علم الكلام" "بعلم النظر والاستدلال".
3.3.1- محاوراً: مقتضى المحاورة أنَّه لا خطاب إلا بين اثنين، لكل منهما مقامان هما مقام المخاطِب ومقام المخاطَب ووظيفتان هما وظيفة العارض ووظيفة المعترض. وقد كانت هذه الصفة الحوارية للمتكلم داعياً إلى حمل الكلام على معنى "المكالمة" والمناظرة وإلى تسمية "علم الكلام" بعلم "المقالات الإسلامية".
وفي هذا الجمع الخاص بين أصول النقل وبين مبادئ العقل الذي تعلقت به همم المتكلمين ما دعا البعض إلى التحفظ في شأن "علم الكلام" والاعتراض عليه بل واستنكاره، وقد وَجَدت هذه المواقف الانتقادية قوة وسنداً في ما وقع فيه بعض "المتكلمين" من شبهات مقصودة وغير مقصودة، وما سلكوه، عن عمد أو غير عمد، من طرق ملتبسة طلبوا بها نصرة آرائهم.
4.1- الامتياز المنهجي والمنطقي للمتكلمين:
ليس غرضنا أن ننحاز إلى موقف معارض لهذه النزعات المنتقدة لِ"علم الكلام"، فننتصر لمذاهب المتكلمين جملة وتفصيلاً، وإنما أن ننظر فيما أصابوا فيه، حتى يتسنى لنا الاستفادة منه في تقدير الطاقة الإبداعية في إنتاجهم؛ ونقدم لهذه التقدير بالملاحظات التالية:
1.4.1- لا يمكن لأحد أن ينكر دور المتكلمين في مواجهة التيارات الاعتقادية غير الإسلامية ـ المنزَّلة منها وغير المنزلة ـ والاتجاهات الفكرية القائمة على العقلانية المادية والنظر غير التوحيدي المعاصرة لهم.
2.4.1- إن المستوى الرفيع الذي حصله "المتكلمون" في ضبط المناهج العقلية والأخذ بالقويم من الأدلة المنطقية يفوق المستوى الذي بلغه من يقوم من "علماء المسلمين" اليوم بالتصدي للمذاهب الفكرية غير الإسلامية، كما يفوق مستوى من يتولَّى من "مفكري العرب" المعاصرين مهمة تجديد التنظير لمناهج البحث في الإنتاج الإسلامي.
ونثبت دعوانا هذه بالدليلين الآتيين:
1.2.4.1- إن "المتكلمين" استوعبوا استيعاباً منهجياً كاملاً مختلف أسباب عصرهم العلمية والتاريخية من وسائل نظرية وأوضاع ظرفية، بينما لا نجد مثل هذا الاستيعاب المنسق لوسائل العصر العلمية والمعطيات التاريخية في ما أُنجِز من الدراسات المعاصرة التي تحاول تطوير الفكر الإسلامي، بل "تثويره" أو على النقيض تَجاوُزه وابتغاء غيره.
2.2.4.1- إن "المتكلمين" انتهجوا في أبحاثهم طرقاً استدلالية تمتاز بالتجريد والدقة، واتبعوا في تحليلاتهم أساليب تمتاز بالطرافة والعمق، بينما لا تستقيم للكتابات المعاصرة عن التراث مثل هذه القدرة على ممارسة مناهج التفكير المنطقي.
3.4.1- إن هذا الامتياز المنهجي والمنطقي "لعلم الكلام" يجعل الطعن فيه جملة وتفصيلاً من لدن خصومه، من القدامى والمحدثين، منطوياً على غلو وحيف كبير، علاوة على ما يقع فيه من أخطاء منهجية نذكر منها:
1.3.4.1- الخلط بين المضمون والمنهج: فقد انْسَاقَ الخصوم إلى إسقاط أحكامهم بصدد الأقوال والموضوعات الكلامية، التي قد تكتنفها بعض الشبهات وتخالطها بعض التوهمات، على الطريقة التي اتُّبِعت في تناولها والتي قد تكون على خلاف ذلك محققة لشروط نظرية صحيحة.
2.3.4.1- الوقوع في استعمال الأساليب "الكلامية" التي أخذوها على "المتكلمين": إذا كان خصوم "علم الكلام" يصوغون انتقاداتهم، سواء بطريقة المناظرة المباشرة أو بطريق المجادلة غير المباشرة، فإنهم يكونونَ قد قاموا بشرط "الكلام"، في حين كان منطقُ موقِفهم المعارض يقتضي منهم الخروج عن هذا الشرط؛ لكن كيف يتأتى لهم الخروج ما دام كل معترض واقعاً في "الكلام"، شاء أم أبى!
3.3.4.1- اعتبار وضع "علم الكلام" في الخطأ والصواب مختلفاً عن وضع العلوم الأخرى: ينصح بعض الخصوم بترك الاشتغال ب"الكلام" بسبب إمكان تسخيره للمفسدة بدل المنفعة. والحق أن هذا الإمكان قائم في كل علم. وما كان ذلك ليحمل المرء على تركه، بل على العكس من ذلك، يحمله على طلب القيم الصحيحة لتوجيه الاستفادة منه، وكذلك الشأن بصدد "علم الكلام"، فبدلاً من أن يطالب الخصوم بتركه، كان الأولى بهم أن يطلبوا القيم المشروعة لتوجيهه وتصويب النظر العقلي فيه.
بعد أن بينا امتياز "منهج المناظرة" ودوره في إنشاء "علم الكلام" وتكوين إنتاجيته الفلسفية، نأتي إلى استخراج بعض سمات "نموذج المناظرة" الإسلامية؛ وسوف يمكننا هذا النموذج من تجديد كشف وفهم التراث الإسلامي، ومن وصف وتحليل أكداس نصوص المناظرات، ومن مراجعة الأحكام التي تأثرنا فيها، من حيث لا نشعر، بتقويم الغرب لهذا التراث، هذا التقويم الذي يستند إلى تصور غير تفاعلي وغير تداولي للخطاب الطبيعي أو قُل تصور يستبعد المخاطب ويثبت الحضور للمتكلم وحده، قبل أن يُغَيِّبَه هو بدوره مُحَوِّلاً كلامه إلى متوالية رياضية لا غير؛ ومما لا شك فيه أن التقويم الغربي للإنتاج الإسلامي يستمد أصله من تسلط عقلانية ديكارت على الفكر الأوروبي عامة والفرنسي خاصة.
كما أن صوغ نموذج المناظرة الذي هو تنظير ل(تصارع الآراء)، سوف يسمح بتكميل تنظيرات أخرى جرت لتصارعات غير كلامية مثل "تصارع الأفراد" و"تصارع الطبقات الاجتماعية" و"تصارع الأنظمة السياسية" و"التنافس على السلطة"، وما إليها، بل إن هذا التنظير قد يمدنا بوسائل لإحكام الربط بين الصنفين من التصارعات: الفكرية والمادية، ولمراقبة وضبط الاستدلال بأحدهما على الآخر، هذا الاستدلال الذي عَجِل إليه الكثيرون ولَمَّا يستوعبوا آليات أحد الطرفين: وهو التنازع الفكري الذي تمثله "المناظرة".
لقد انتبه ابن خلدون إلى هجران المسلمين لهذا المبحث عند ذكره لطريقتين في "المناظرة" عندهم: طريقة البزدوي الخاصة بالأدلة الشرعية وطريقة العميدي العامة؛ ولا نذهب بعيداً لنتبين هذا الإهمال، فابن خلدون نفسه خلط بين وظيفتي "السائل" و"المستدل"، وكذلك بين قانوني "الاعتراض" و"المعارضة"، ولا نستغرب من ابن خلدون وقوعه في هذه الهفوات، وهو الذي أقصى المنهج الجدلي من مشروعه في تأسيس علم عمراني وطلب هذا التأسيس "بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه"1.
وممن يذكرهم حاجي خليفة في كشف الظنون باعتبارهم رتبوا قوانين "علم المناظرة": شمس الدين السمرقندي (المتوفى سنة 606ه) وعضد الدين الإيجي (المتوفى سنة 756ه) وطاش كُبرى (المتوفى سنة 963ه) 2 .
** المصدر:في أصول الحديد وتجديد علم الكلام ص 69 - 74
الهوامش:
1ـ ابن خلدون، المقدمة، ط. القاهرة، باب الجدال، ص. 457-458.
2ـ حاجي خليفة، كشف الظنون، ص. 38-42.
الآراء الواردة في هذه الصفحة تعبر عن آراء أصحابها فقط؛ ولا تعبر بالضرورة عن رأي دار الأمير للثقافة والعلوم. |