من هم المؤرخون المراجعون،
ولماذا يجب أن تعنينا "المحرقة" اليهودية؟
بقلم: د. إبراهيم ناجي علوش.
بين الأسطورة والحقيقة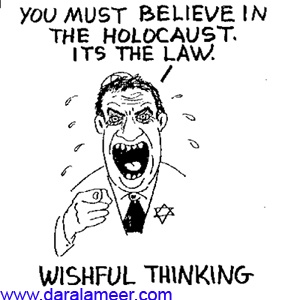
أثار إلغاء مؤتمر المؤرخين المراجعين في بيروت، الذي كان سينعقد في آخر آذار من عام 2001، والتأجيل القسري لندوة رابطة الكتاب الأردنيين مرتين متتاليتين، تساؤلين:
1. من هم المؤرخون المراجعون؟
2. ولماذا تعنينا قضية ما يسمى بالمحرقة اليهودية؟
ولم تكن هذه كل التساؤلات التي أثارتها خلال شهر نيسان 2001 جهود الحركة الصهيونية الحثيثة لمنع مؤتمر المؤرخين المراجعين في بيروت أو ندوة رابطة الكتاب عن المؤرخين المراجعين في الأردن، أو بيان المثقفين العرب الأربعة عشر، الذي دعا الحكومة اللبنانية إلى منع مؤتمر المراجعين في بيروت مقدماً بذلك غطاءاً ثقافياً عربياً للجهود الصهيونية ولقمع النظام العربي للثقافة والمثقف.
1- من هم المؤرخون المراجعون؟
تدعي الحركة الصهيونية، من خلال وسائل الإعلام الضخمة التي تسيطر عليها، أن المؤرخين المراجعين ليسوا إلا حفنة من الأصوليين المسيحيين المعادين للسامية. ولكن الحقيقة هي أن المراجعة التاريخية ليست إيديولوجية أو تياراً مذهبياً أو دينياً. إذ يوجد بين المؤرخين المراجعين مسلمون ومسيحيون وماركسيون وحتى يهود، ويوجد بينهم عرب وأوروبيون وأمريكان. فالمراجعة التاريخية ليست عصبية عرقية أو مذهبية، بل موقف انبثق عن منهج في التحليل تدعمه الأدلة والأساليب العلمية حول قضية تاريخية محددة هي الحرب العالمية وإرهاصاتها، وعلى رأسها ما يسمى بالمحرقة اليهودية.
وقد تعرض المؤرخون المراجعون على اختلاف أصنافهم، بسبب تبنيهم لهذا المنهج في تحليل ما يسمى "المحرقة" أو الهولوكوست، لاضطهاد شديد وعزل اجتماعي وطرد من الوظائف وسجن وغرامات باهظة وعمليات اغتيال.
واليوم، أصبح التعبير عن آراء مؤيدة للمراجعين جريمةً يعاقب عليها القانون في العديد من الدول الغربية التي تدعي خلاف ذلك أنها تدافع عن حرية الرأي.
2- هل ينكر المؤرخون المراجعون أن يهود ماتوا في الحرب العالمية الثانية؟
لا، لا ينكر المؤرخون المراجعون أن يهود ماتوا في الحرب العالمية الثانية. لكنهم يقولون أن بضع مئات الآلاف من اليهود هلكوا في حرب بلغ عدد ضحاياها خمس وأربعين مليون نسمة. وقد استخدم المؤرخون المراجعون العلوم الدقيقة مثل الفيزياء والكيمياء ليثبتوا أن اليهود لم يبادوا بشكل منهجي في غرف غاز مزعومة كما تدعي الرواية الرسمية حول الهولوكوست.
وقالوا أن المحارق كانت تستخدم للتخلص من جثث الموتى من جنسيات مختلفة، وليس اليهود فقط، بعد موتهم، لتجنب الأوبئة. لكن محارق الموتى شيء يختلف تماماً عن غرف الغاز المزعومة. وتشير الدلائل العلمية أن غرف الغاز لم توجد أبداً . وتدل أبحاث المؤرخين المراجعين أن معظم الذين ادعى الصهاينة أنهم قضوا في غرف الغاز، ماتوا في الواقع بسبب مرض التيفوس، مثل الطفلة آني فرانك التي زوروا مذكراتها وجعلوا منها أسطورة مقدسة لا تمس في الغرب. فالمحرقة اليهودية صنمٌ صنعته الحركة الصهيونية في الثلث الأخير من القرن العشرين، والمؤرخون المراجعون في هذا السياق هم محطمو الأصنام.
المؤرخون المراجعون إذن لا ينكرون أن يهود ماتوا في الحرب العالمية الثانية، ولكنهم يستخدمون العلم في تكذيب الرواية الرسمية عن المحرقة في ثلاثة جوانب محددة هي:
أ) عدد اليهود الذين ماتوا في الحرب العالمية الثانية.
ب) الطريقة التي مات بها هؤلاء.
ج) التمييز المزعوم وفرادة موت اليهود في التاريخ البشري بأسره.
3- لماذا تعنينا قضية "المحرقة" اليهودية؟
كثيراً ما يعرب الفلسطينيون والعرب والمسلمون عن إحباطهم باللامبالاة التي يقابل فيها الرأي العام الغربي المعاناة الفلسطينية والعربية على أيدي الحركة الصهيونية. والواقع أن الصهاينة نجحوا بتقديم أنفسهم للرأي العام الغربي كشعب لقي من الويلات في "المحرقة" ما يعطيه حق ارتكاب أي عمل ضد أي شخص في أي وقت بدون أي وازع. وغالباً ما يلوم العرب أنفسهم على التقصير الإعلامي الذي يعتقدون أنه يكمن في عدم قدرتهم على إيصال صورة صحيحة عن معاناتهم إلى الرأي العام الغربي. لكن الغرب لا تنقصه المقدرة على معرفة ما يعانيه العرب على أيدي الصهاينة، فهو يعرفه، لكنه يقلل من أهميته لأن صورة "المحرقة" قابعة ابدأً في خلفية عقله الجمعي ووسائل إعلامه، لذلك تتضاءل المعاناة العربية الحقيقية أمام المحرقة اليهودية المزعومة، وهنا تكمن المشكلة الأساسية.
وكشخص عاش وعمل ودرس وعلمَّ وكتب في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ثلاثة عشر عاماً، كنت من العرب الذين يجيبون حين يسمعون "المحرقة" تساق دفاعاً عن الحركة الصهيونية: لماذا يجب أن ندفع ثمنها نحن؟! فلا أحد، حتى اليهود أنفسهم، يتهمون العرب بأنهم هم الذين ارتكبوا المحرقة. وقد كنت أقود السيارة مرة عبر ولاية اركنسا، ولاية الرئيس السابق كلينتون، باتجاه ولاية أوكلاهوما، فوجدت بلدة صغيرة هناك اسمها فلسطين، وهناك بلدات كثيرة في الولايات المتحدة بهذا الاسم، فدخلتها ووجدت حولها أراض زراعية شاسعة، ثم بضعة آبار من النفط، فكتبت مقالة دعوت فيها الرئيس كلينتون أن يعطي اليهود فلسطين الموجودة في ولايته إذا كان يحبهم إلى هذه الدرجة، لعلهم يرحلون عن فلسطين العربية، لكن مسائل الجغرافية السياسية ليست بهذه البساطة، و"المحرقة" أقوى من المنطق.
إن أساطير "المحرقة" مهمة جداً بالنسبة للحركة الصهيونية، وبالتالي بالنسبة لنا، للأسباب التالية:
أ) إن الإدعاء القائل بأن اليهود أبيدوا بشكل منهجي من قبل الألمان في الحرب العالمية الثانية أصبح حجة لا تناقش حول ضرورة إيجاد ملجأ آمن لليهود في دولة خاصة بهم. "فالمحرقة" تعني الحاجة لوجود "إسرائيل"، وهذا معنوياً أقوى من الاعتراف بحقها بالوجود. وعندما لا يكتفي الصهاينة بالاعتراف القانوني، بناءاً على قرارات الأمم المتحدة الظالمة أو غيرها، بحقهم في الوجود، فإنهم يطالبون فعلياً بأن تعترف الأنظمة العربية بالحاجة اليهودية لوجود "إسرائيل". باختصار، إن "المحرقة" تبرر اغتصاب أرض فلسطين أمام العالم، والمطلوب الآن أن ينتقل العرب من الاعتراف بهذا الاغتصاب على مضض، بالقوة، إلى الاعتراف بالحاجة اليهودية إلى ممارسة هذا الاغتصاب من خلال اجترار أساطير "المحرقة"، فالمحرقة هي جوهر الاعتراف الثقافي بحق العدو بالوجود.
وكما قال الكاتب اليساري الصهيوني يوري أفنيري، ولا فرق بين اليمين واليسار في الكيان الصهيوني، أن اليهود مثل رجل قفز من مبنى يحترق فوقع على رأس رجل يسير في الشارع، واليهود وقعوا على رؤوس الفلسطينيين، فهم "ضحايا"، والفلسطينيون ضحايا "الضحايا"، ولذلك لا يتعاطف العالم معهم، كما تعاطف مع الأفارقة في جنوب إفريقيا، فلا مجال لمقارنة الإبادة [المزعومة] لملايين اليهود في :المحرقة"، بالاقتلاع [الحقيقي] لبضع مئات الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم.
الأهمية السياسية لأسطورة المحرقة
المراجعة التاريخية إذن ليست مؤامرة لإنكار "المحرقة" بل طريقة لوضعها ضمن إطارها العلمي، وبالتالي لوضع قيام "إسرائيل" ضمن إطارها العلمي، فالمسألة راهنة سياسياً، وليست مجرد قضية أكاديمية تخص المؤرخين. وإذا كان الإدعاء القائل بأن اليهود أبيدوا بشكل منهجي من قبل الألمان قد اصبح حجة لا تناقش حول ضرورة إيجاد ملجأ آمن لليهود في دولة خاصة بهم، وبالتالي الحاجة إلى وجود "إسرائيل" في نظر الرأي العام العربي، كما جاء سابقاً، فإن هنالك فوائد سياسية راهنة للجوانب الأخرى من أسطورة "المحرقة" أيضاً.
ب) إن الإدعاء القائل أن اليهود أبيدوا بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ البشري برمته، وهو ما يسمى بفرادة موت اليهود، أي أن اليهود ليسوا فقط شعب الله المختار كما يزعمون، بل أن موتهم نفسه غير موت بني البشر باعتبار أنهم فقدوا حسب زعمهم ستة ملايين على أيدي النازيين، هو الأمر الذي يستطيع أن يجعل من موت أي صهيوني اليوم في الصراع العربي – الصهيوني أكثر أهمية من استشهاد أي فلسطيني أو عربي أو مسلم. نلاحظ طبعاً هذه الازدواجية بوضوح في طريقة تعامل الإعلام الغربي مع موت الصهاينة وطريقته في التعامل مع قتل الصهاينة للعرب، وغالباً ما تعزا هذه الازدواجية لاعتبارات سياسية محضة، ولكن الازدواجية لا تقتصر على الإعلام الغربي، بل تتعداها عامة وليس دائما،ً إلى المواطن الغربي نفسه الذي تبرمج ثقافياً، من خلال جانب فرادة موت اليهود في أسطورة "المحرقة"، على التعامل مع موت اليهود بحساسية فريدة من نوعها.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فأسطورة فرادة موت اليهود في "المحرقة" وشدة معاناتهم فيها بشكل لا نظير له في التاريخ، تقدم المسوغات الأخلاقية لدولة "إسرائيل" وللحركة الصهيونية العالمية لانتهاك كل الأعراف الدينية والدنيوية المعروفة للبشر وقوانين الأمم المتحدة بدون معارضة المواطن الغربي، وحتى بتعاطفه. وهذا الأمر هو الذي يضيء الجانب الثقافي في تعاطف، أو على الأقل سكوت، المواطن الغربي على قيام "إسرائيل" بقصف العراق وتونس ولبنان، وحيازة الأسلحة النووية، في الوقت الذي يمدد فيه الحصار على العراق بحجة عدم سماحه بالتفتيش عن أسلحة أقل شأناً.
ج) إن الإدعاء القائل أن بلدان وشعوب الغرب تتحمل مجتمعة ذنباً جماعياً تاريخياً على جريمة "المحرقة" المزعومة، وترسيخ عقدة الذنب الجماعية هذه في أذهان الغربيين من خلال وسائل الإعلام والترفيه والمناهج المدرسية، هو الجذر الأساسي لدعم الرأي العام الغربي لدولة "إسرائيل" والحركة الصهيونية. وقد كان هذا الشعور الغربي العام بالذنب الجماعي ظاهرة اجتماعية – سياسية حديثة نسبياً تبلورت بعد حرب عام 1967، وليس بعد الحرب العالمية الثانية، حسب الكاتب اليهودي الأمريكي نورمان فينكلشتين في كتابه عن استغلال "المحرقة" لأغراض سياسية الذي صدر عام 2000 تحت عنوان "صناعة الهولوكوست".
ويقول نورمان فينلكشتين في كتابه أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة كان يتجنب إثارة "المحرقة" في وجه ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة تساوقاً مع الاستراتيجية الأمريكية العالمية في تجنيد ألمانيا وباقي دول أوروبا الغربية في مواجهة الاتحاد السوفياتي.
المهم، أصبحت عقدة الذنب الجماعية مصدراً مهماً للدعم المالي والعسكري والتقني والسياسي الذي لم تكن "إسرائيل" لتقوم أو تستمر بدونه، وقد كتب غيري عن هذا الجانب في أسطورة "المحرقة"، لذلك لن أسهب فيه، باستثناء الإشارة إلى أن عقدة الذنب الجماعية تجاه اليهود والحركة الصهيونية ليست صنيعة الحركة الصهيونية وحدها، بل هي حاجة سياسية للحكومات الغربية نفسها التي تدعم "إسرائيل" لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية.. ففي الدول الغربية التي تتمتع بهامش نسبي من الديمقراطية يجب أن يتقولب المواطن على دعم "إسرائيل" والحركة الصهيونية قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع، و"المحرقة" تصبح هنا الرافعة الثقافية لوعي سياسي لا يتساوق مع مصالح الحركة الصهيونية فحسب، بل مع مصالح النخب الحاكمة في الغرب أيضاً.
ونخلص من كل ما سبق عن أهمية "المحرقة" السياسية إلى السبب الذي يجعل المؤرخين المراجعين بخلفياتهم الإيديولوجية المتنوعة يشكلون مثل هذا الخطر الجدي على الحركة الصهيونية وحلفائها: أنهم يستخدمون العلم والعقل في التشكيك بكل جانب من جوانب "المحرقة" المزعومة، فيحرقونها ببرد المنطق وماء الأقلام، ثم يبددونها بعد كشف هياكلها السياسية الصهيونية كالرماد المنثور.
إن المؤرخين المراجعين إذن يهددون ببتر الشريان الذي تتغذى منه الحركة الصهيونية في الغرب، ولذلك يحاصرون ويتعرضون لعمليات الاغتيال والتجويع. ولكن جهودهم ومواقفهم تجعلهم حليفاً لا غنى عنه للفلسطينيين والعرب والمسلمين، حليفاً خليقاً بالدعم والمساندة والتشجيع منا ومن كل المدافعين عن الحقيقة والعدالة في العالم. وكما قال لي أحد أنصار المؤرخين المراجعين في أوروبا: "لن تتحرر فلسطين حتى تتحرر عقول الأوروبيين من المحرقة".
بالمقابل، نجد بعض المثقفين العرب وقد خدعهم أنصار الصهيونية بفكرة مفادها أن جعل القضية الفلسطينية تلقى القبول في الغرب يتطلب منهم الاعتراف بالنسخة الصهيونية لأسطورة "المحرقة"، ويتطلب منهم المشاركة باضطهاد المؤرخين المراجعين. ولكن هذا سلوك انتحاري من وجهة النظر السياسية، فالاعتراف بالادعاءات الصهيونية عن "المحرقة" يمهد الطريق لما يلي الاعتراف بها، مثل:
أ) القبول باغتصاب فلسطين وبمشروعية الغزو اليهودي لها من خلال قبول الرواية الصهيونية عن المبرر الذي "اضطر" اليهود للمجيء إليها.
ب) القبول ضمنياً بالغطاء الثقافي للدعم السياسي والمالي والمعنوي الذي يقدمه الغرب للحركة الصهيونية، الأمر الذي يعيق الجهود المخلصة للعديد من العرب الناشطين في الغرب من أجل كسب التأييد للقضية الفلسطينية.
ج) القبول ضمنياً بأحد دوافع الحصار على العراق، فالعراق يعتبر أولاً وأخيراً خطراً على "إسرائيل"، وتختلط ذكرى تدمير العراقيين القدامى لمملكة إسرائيل البائدة قبل آلاف الأعوام، وأسطورة "المحرقة" في هذا السياق، مع الصواريخ التي وقعت على تل أبيب في حرب الخليج الثانية، لإعطاء صورة قاتمة عن شعب يهودي تحت خطر دائم يتطلب رده استمرار الحصار على العراق بعد أكثر من عشر سنوات على خروجه من الكويت. وعندما يقول الساسة الغربيون أن العراق يشكل خطراً على جيرانه، من تعتقدون أنه المقصود بهذا القول أكثر من "إسرائيل"؟
بالتالي، ليس من المجدي للإنسان العربي أن ينال القبول الفردي في الغرب عن طريق الاعتراف بالرواية الصهيونية عن "المحرقة"، لأن ثمن هذا القبول الفردي سيكون الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني، وهذا الثمن لا قبل للشرفاء به.
القادة والرموز
- المؤرخون المراجعون: لمحة عامة عن القادة والرموز.
ليس روجيه غارودي واحداً من أهم الكتّاب المراجعين، مع أن كتابة "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية" يعتبر الجسر الذي أتت عبره المراجعة التاريخية إلى العالمين العربي والإسلامي. وتكاد لا تجد ذكراً لروجيه غارودي بين المراجع والمصادر التي يستخدمها الكتاب المراجعون في أبحاثهم. لكن روجيه غارودي رغماً عن ذلك يبقى شخصية مهمة في حركة المراجعة التاريخية لأنه أولاً قام بتلخيص وتبسيط كتابات المراجعين الأكاديمية المعقدة الموجودة في مجلداتهم الضخمة، ومعظمهم من المتخصصين، ولأنه ثانياً سمح من خلال هذا التبسيط والتلخيص بتعريف القارئ العربي والمسلم بالمراجعة التاريخية. ولكنه لم يقدم جديداً في مجال المراجعة، ولم يضم تلخيصه كل مهم فيها، حسب رأي معظم المراجعين.
ولكن التعريف شيء، والمعرفة شيء آخر، والمقدمة شيء، والمتن شيء آخر. فهنالك بين المراجعين أشخاص ومعاهدٍ تعمل في هذا المجال منذ عقود، وهم يعتبرون روجيه غارودي طارئٍ جديداً على هذا الحقل، دون أن يقلل ذلك من تقديرهم لدوره في إيصال المراجعة إلى الجمهور العربي والإسلامي. بيد أن النبع الذي نهل منه روجيه غارودي فعلاً، والذي ينهل منه العديد من المراجعين، هو أستاذ الأدب الدكتور روبرت فوريسون، الذي تعرض لاضطهاد حقيقي بسبب مواقفه في فرنسا، والذي تعرض لاعتداءات جسدية كادت تودي به، وللطرد من العمل والحرمان من راتبه التقاعدي. روبرت فوريسون، وأبوه فرنسي وأمه اسكتلندية يعتبر أهم كاتب مراجع على قيد الحياة اليوم، ورغم كبر سنه، فإن صلابته وتعمقه في المراجعة جعله عن حقٍ إمامها.
وهنالك أيضاً معهدان، واحد في سويسرا، واسمه معهد الحقيقة والعدالة، ورئيسه الدكتور يورغن غراف، الهارب حالياً من بلاده، بسبب حكم قضائي صادر ضده بالسجن بسبب مواقفه المراجعة، وهنالك معهد المراجعة التاريخية في الولايات المتحدة، ورئيسه الدكتور مارك وبر. هذان المعهدان يعتبران أهم معهدين للمراجعة التاريخية في العالم، ولكن هنالك معاهد ومراكز أخرى مثل معهد كارتو في الولايات المتحدة الذي يعتبر انشقاقاً عن معهد المراجعة التاريخية في الولايات المتحدة، وبينهما ما صنع الحداد، من التشكيك إلى المحاكم إلى التهم بالاختلاس. وقد حاولت فهم طبيعة الخلاف بينهما، فوصلت إلى أن معهد كارتو تمكن بطريقة ما من الاستحواذ عن مبالغ يقول معهد المراجعة التاريخية إنها تعود له، مما كاد يودي بالمعهد الأخير إلى الإفلاس، ولكنه عاد ووقف على قدميه كبؤرة أساسية للمراجعة التاريخية في الولايات المتحدة والعالم، وقد اشرف على أكبر مؤتمر عالمي للكتاب المراجعين في ولاية كاليفورنيا في أيار/مايو من عام 2000.
ومع أن بعض أنصار المراجعة التاريخية قد يلومني على ذكر هذا الخلاف المؤسف بين معهدي المراجعة التاريخية في الولايات المتحدة، الذي يتخذ الكثير من المراجعين، على سبيل المثال يورغن غراف، رئيس معهد الحقيقة والعدالة السويسري، موقفاً حيادياً إزاءه، فأني آثرت الإشارة إليه، لا لأن هذا النوع من الخلافات ليس حكراً على المراجعين بل ينتشر في معظم الحركات الفكرية والسياسية فحسب، بل للتأكيد على مقدار التنوع واختلاف التوجهات بين المراجعين أنفسهم. فالمراجعة التاريخية ليست إيديولوجية أو حركة سياسية، بل طريقة في معالجة مسألة محددة هي "المحرقة"، والحرب العالمية الثانية وأثارها السياسية وغير السياسية. فعلى حد قول فوريسون: "إن المراجعة محاولة لتفحص وتصحيح ما هو مقبول عامة بغرض التثبت بدقة من طبيعة شيء أو حقيقة واقعة أو قيمة رقم أو أصالة ومصداقية وأهمية نص أو وثيقة".
من بين كبار المراجعين مثلاً المؤرخ البريطاني ديفيد ايرفينغ الذي تعرض لمحاكمة وحكم جزائي مقداره مئتا ألف دولار عام ألفين بسبب مواقفه، والذي منعت له محاضرة في بريطانيا في أيار/مايو من عام (2001). رغم ذلك، فإن فوريسون يعتبر ايرفينغ، مثل غارودي، غير صلب بما فيه الكفاية، ويعتبر أنه يحاول الترويج للمراجعة بطرق "ديبلوماسية" تضعف من موقفها العلمي والمبدئي.
وهنالك بين المراجعين علماء مثل الكيميائي الشاب الألماني غيرمار رودلف الهارب من بلاده منذ 1996 بسبب حكم قضائي بسجنه 14 شهراً بعد قيامه بتحليل مختبري لمعسكرات الاعتقال النازية في أوشقنر وباركينا أثبت فيه تهافت نظرية "غرف الغاز". وبين العلماء منهم، هناك الدكتور الأمريكي أرثر بوتز، بروفيسور الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب، الذي وضع مجلداً جامعاً مانعاً، يدحض فيه أسطورة "المحرقة" اعتماداً على العلم الهندسي والفيزياء والكيمياء.
ومن بين الكتّاب المراجعين اليهود، هناك الكاتب الصحفي جون ساك الذي وضع كتاباً عن قيام اليهود بقتل ما بين ستين وثمانين ألف ألماني في معسكرات اعتقال في بولندا بعد الحرب العالمية الثانية، مما أثار حفيظة الصهاينة عليه.
مقابل جون ساك، هناك المراجع الكندي، أرنست زوندل، وهو ألماني الأصل، ويبدو من كتاباته أنه متعاطف مع النازية، وأن دوافعه كمراجع تتعلق بمحاولة تبرئة ألمانيا من تهمة "المحرقة" الموجهة إليها. وقد تعرض أرنست زوندل للمحاكمة مرتين في كندا، ذهب بعدها إلى الولايات المتحدة حيث يعيش مع زوجته انغريد الألمانية الأصل أيضاً، وهما هناك من قيادات المراجعين، ويبدو أن ثمة روابط تربطهما باليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا، والله أعلم.
وهناك أيضاً المؤرخ المراجع روبرت كاونتس، وهو ضابط سابق في الجيش الأمريكي وكاهن مسيحي أصبح يجوب البلدان للتبشير بالمراجعة التاريخية، وهناك العربي المسلم أحمد رامي الذي يعتبره المراجعون من رموزهم، ولن أتحدث عنه بل أنصح الأخوة القراء بالذهاب إلى موقعه على الإنترنت وهو: http://abbc2.com والموقع يضم أقساماً بالعربية.
وهنالك اليساريان الفرنسيان سيرج تيون، وبيار غييوم، والأخير هو ناشر كتب روجيه غارودي عن المراجعة، ويعادي هذان المراجعان النازية بالتأكيد، وقد تعرضا لاضطهاد شرس واعتداءات مثلهما مثل باقي المراجعين.
الخلاصة، إن المراجعة التاريخية موقف فكري وسياسي يضم شخصيات ومؤسسات من مشارب فكرية وإيديولوجية مختلفة، متضاربة أحياناً، يجمعها معنا عداءها للصهيونية، ويجمعها مع بعضها الاضطهاد الوحشي الذي يتعرض له كل من يتمسك بها.
ما يهمّنا في أبحاث المراجعين التاريخيين
- هل يجب أن نوافق على كل شيء يقوله المؤرخون المراجعون؟
والجواب على هذا السؤال، بدون مقدمات، هو لا بالقطع. فالمراجعة التاريخية مشروع بحثي قيد التنفيذ، وصل إلى بعض الاستنتاجات العلمية والتاريخية ذات الأبعاد السياسية الخطيرة، ولكنه لم يكتمل بعد، خاصة في ظل ظروف القمع الرهيبة وشح الموارد التي يعيشها الكتّاب المراجعون.
كما أن الكتّاب المراجعين ينطلقون من خلفيات عقائدية مختلفة تمتد من أقصى اليمن إلى أقصى اليسار، ومن دوافع متشابكة تمتد من الالتزام المبدئي بحرية البحث العلمي ونتائجه إلى الرغبة بكشف وسائل الابتزاز الصهيونية للرأي العام الغربي من خلال الجوانب المختلفة في أسطورة "المحرقة" إلى الرغبة بتبرئة ألمانيا النازية من التهم الموجهة إليها إلى معاداة الصهيونية. وإذا كنا قد نختلف مع بعض المراجعين في بعض منطلقاتهم، وإذا كنا ننطلق في معاداة الصهيونية من منطلقات أوسع بكثير من الطريقة التي تتلاعب بها بأسطورة "المحرقة"، فإن هذا لا يقلل من أهمية المراجعة التاريخية، ولا يقلل من أهمية الأبعاد السياسية لاستنتاجاتها. فالمراجعون، بمنطلقاتهم المتعددة، يساهمون عملياً بكسر هيمنة الحركة الصهيونية على الغرب، وهذا هو السبب الذي يجعلهم عرضة للمطاردة والاضطهاد.
وهم يفعلون ذلك من خلال استنتاجاتهم العلمية والتاريخية. فما يهمنا من المراجعة هو أسلوبها العلمي ونتائج أبحاثها والأبعاد السياسية لهذه النتائج، وليس الخلاف مع منطلقات بعض، وليس جميع، الذين يتبعون منهج المراجعة التاريخية. فما يهم هنا هو الاصطفاف الموضوعي للقوى في ساحة الصراع، وليس الوصول إلى اتفاق إيديولوجي كامل مع كل مراجع حول كل مسألة على جدول البحث، لا بل أن عدم الوصول إلى هكذا اتفاق لا يمنع، ولا يجوز أن يمنع، على مستوانا العربي اتفاق مناضلين إسلاميين وقوميين ويساريين على مقاومة الصهيونية في بلادنا.
على الرغم من ذلك، فإن ثمة ثغرة سياسية أساسية في أبحاث معظم المراجعين الذين أطلعت على كتاباتهم، ولا أقول أنني أطلعت على كل كتاباتهم، وهي أنهم لا يعطون أهمية كافية للدور الذي تلعبه النخب الحاكمة في الغرب لفرض أسطورة "المحرقة". والمسألة يمكن وضعها بالشكل التالي:
إذا اتفقنا مع المراجعين أن موت اليهود في الحرب العالمية الثانية لم يكن فريداً من نوعه ولا غير مسبوق، وإذا اتفقنا معهم أن غرف الغاز وهم لم يتمكن أحد من إثبات وجوده حتى الآن وأن رقم الستة ملايين مبالغ فيه حتى الثمالة، وإن مئات الآلاف من اليهود ماتوا مع غيرهم بسبب الجوع والمرض خلال أو بعد علميات ترحيلهم الجماعية، والدلائل تشير إلى أن كل هذه الاستنتاجات صحيحة، وإذا اتفقنا معهم بالتالي أن اليهود لم يأتوا بمئات الآلاف بعد الحرب العالمية الثانية إلى فلسطين هرباً من "المحرقة" المزعومة، فإن السؤال الذي بقى هو: لماذا أتوا إلى فلسطين إذن؟ لماذا جاءت بهم الحركة الصهيونية إلى بلادنا لتأسيس مستعمرة يهودية فيها.
المراجعون يعرفون أيضاً أن الدول الغربية كانت تفتح وتغلق أبواب الهجرة اليهودية إليها، أي إلى الدول الغربية نفسها، في محاولة لجعل اليهود يذهبون إلى فلسطين. فلماذا تفعل بريطانيا وبقية الدول الغربية ذلك؟
والإجابة على هذا السؤال المهمل من معظم الكتاب المراجعين حسب علمي هو أن الغرب بدأ يفكر بتأسيس دولة يهودية في فلسطين منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر كإجراء احترازي لمنع قيام دولة عربية موحدة بعد دخول محمد علي باشا من مصر إلى بلاد الشام والى الجزيرة العربية. فالمصالح الاستراتيجية العليا لبريطانيا وللرأسمالية الغربية آنذاك كانت تقتضي تأسيس قاعدة في فلسطين تشكل جسراً بشرياً غريباً ما بين الجناح الأسيوي والجناح الإفريقي للوطن العربي. وقد كشف الدكتور عبد الوهاب الكيالي في كتابه "تاريخ فلسطين الحديث" مراسلات الفيكونت بالمرستون في بريطانيا مع سفيره في اسطنبول حول هذه المسألة بالذات، وكشف آخرون مراسلات بالمرستون مع اللورد روتشيلد بالاتجاه نفسه.
إن الحاجة لقاعدة استعمارية في فلسطين وجسم بشري غريب فيها، أي الحاجة إلى "إسرائيل" أصبحت ماسة اليوم أكثر مما كانت في النصف الأول من القرن التاسع عشر. بالتالي، إن حشد الدعم الشعبي لدولة "إسرائيل" في المجتمعات الغربية المتمتعة بقدر نسبي من الديمقراطية، وتبرير كل العون المالي والعسكري والسياسي المقدم لها، يقتضي أن يعتنق الرأي العام الغربي بالضرورة الوجوه المختلفة من أسطورة "المحرقة" بحماسة. وهذا يجب أن يحدث ليس بسبب سطوة الحركة الصهيونية فحسب، بل لأن النخب الحاكمة في الغرب تشتق فوائد استراتيجية وجغرافية سياسية من إنشاء وإبقاء قاعدة "إسرائيل" العسكرية في فلسطين.
أما نسب كل الدعم المقدم من الغرب للحركة الصهيونية و"إسرائيل" لنفوذ وسطوة الصهيونية في الغرب، فيتجاهل تاريخاً كاملاً من الاستعمار، وقوانين حركة راس المال في المجتمعات الغربية نفسها، واستراتيجيات فرّق تسد واستراتيجيات الاستغلال الاقتصادي التي يمارسها الغرب. في الواقع إن نسب كل الدعم الغربي للصهيونية للتأثيرات الصهيونية على الغرب قد يقود المرء إلى ارتكاب خطأ سياسي فادح من نوع آخر وهو إيهام أنفسنا أن التساوق مع السياسات الاستعمارية الجديدة للحكومات الغربية في بلادنا قد يساعد على تخليصها من التأثيرات الصهيونية عليها. الخطأ السياسي الأول هو بالطبع ذاك الذي ارتكبه بعض الموقعين على عريضة المثقفين العرب التي تطالب الحكومة اللبنانية بمنع مؤتمر "المراجعة والصهيونية" في بيروت. وهذا الخطأ يتلخص بالتوهم أن التساوق مع ادعاءات "المحرقة" أو التطبيع مع العدو الصهيوني قد يساعد على كسب الغرب إلى جانب القضية العربية.
في الحقيقة، إن الخطأين وجهان لعملة واحدة، عملة عدم إدراك العلاقة العضوية بين الصهيونية من جهة، والإمبريالية والاستعمار من جهة أخرى. والخلاصة إننا لسنا من مروجي الكراهية والبغضاء ضد أحد، ولكن الحركة الصهيونية والغرب حينما أتيا باليهود إلى فلسطين لإقامة مستعمرة فيها عرضوهم للخطر الشديد، فهما الخطر الحقيقي الذي يجب أن يحذره اليهود. ولسنا نحن الخطر، بل نحن شعبٌ لن يبخل بشيء من أجل استعادة أرضه.
الآراء الواردة في هذه الصفحة تعبر عن آراء أصحابها فقط؛ ولا تعبر بالضرورة عن رأي دار الأمير للثقافة والعلوم. |



